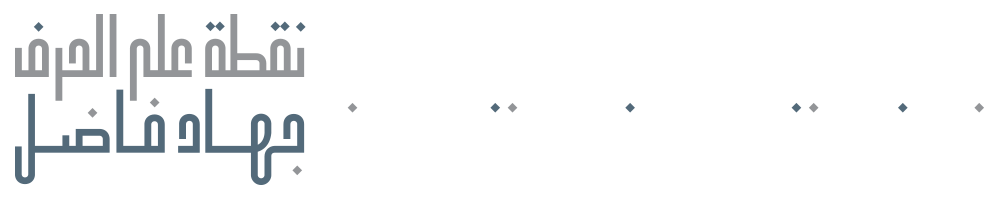دراسات أدبية
شوقي بزيع وجهاد فاضل نزار قباني: الشعر معادل الحياة، والجسد قبَّة الروح شاعر المرأة لا شاعر الأمة جاء نزار قباني إلى العالم في الحادي والعشرين من مارس "آذار" عام 1923 م، ورحل عنه في نهاية أبريل "نيسان" عام 1998 م، خمسة وسبعون عاماً بالتمام والكمال هي مجمل رحلته المليئة بالأحداث والمفتوحة على المغامرة، ...